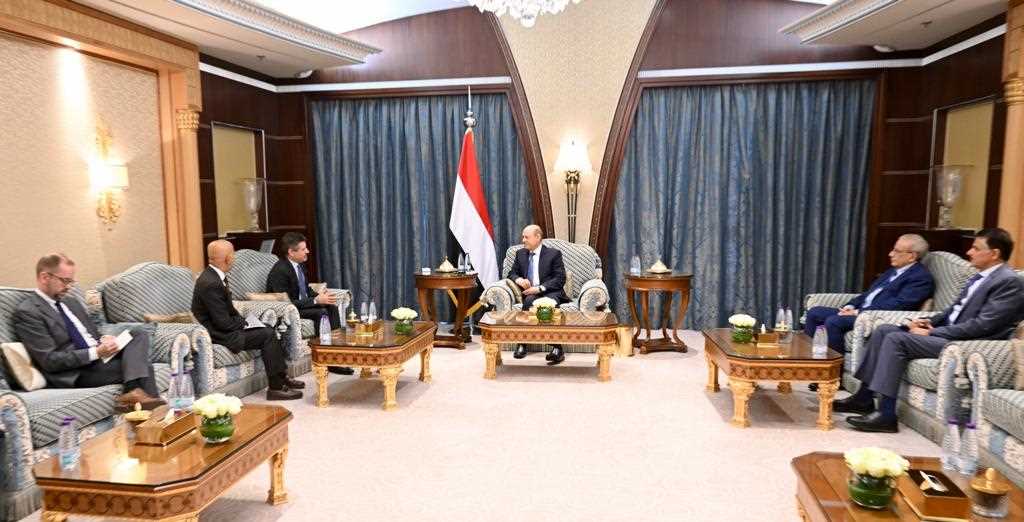في كل مرحلة انتقال أو محاولة إصلاح، يكثر التشكيك، وتتصاعد الاتهامات، ويتوزع الناس بين متفائل حدّ السذاجة ومتشائم حدّ العدمية. وبين هذين الطرفين، نقف نحن — كمنظمات مجتمع مدني وكُتّاب رأي — نحاول أن نؤدي دورًا يبدو للبعض ملتبسًا، لكنه في حقيقته واضح وبسيط: أن نكون صوت الناس وعيونهم في مساحات القرار.
نحن لا نشارك في اللقاءات والحوارات تزكيةً لأحد، ولا نصطف خلف مسؤول بعينه، ولا نملك صكوك براءة نوزعها على النوايا. وجودنا في أي نقاش معني بالإصلاح ليس شهادة حسن سلوك، بل ممارسة لحق أصيل وواجب أخلاقي: أن نطرح هموم الناس، أن ننقل معاناتهم، أن نضع أمام المسؤولين صورة الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يبدو.
لسنا مسؤولين عن نوايا المسؤولين، لكننا مسؤولون عن مواقفنا. الزمن كفيل بكشف من يحوّل الخطاب إلى أفعال، ومن يكتفي بإعادة تدوير الوعود. أما نحن، فوظيفتنا لا تبدأ بالتصفيق ولا تنتهي بالصمت، بل تقوم على المراقبة، والتقييم، والتقويم.
الواقع يحتم علينا أن ندعم أي خطوة إصلاح حقيقية، مهما كانت محدودة. فالمجتمعات لا تنهض بالقفزات الكبرى فقط، بل بتراكم الخطوات الصغيرة. التفاؤل ليس ضعفًا، كما أن النقد ليس عداءً. بينهما مساحة واسعة اسمها “المسؤولية”.
في البدايات، حين تُعلن مشاريع الإصلاح، نكون عيون المواطن التي تراقب، وصوته الذي يوجه، وضميره الذي ينتقد. نساند ما يستحق المساندة، وننتقد ما يستحق النقد، دون أن ننجر إلى خطاب إحباط يُغلق الأبواب، أو خطاب تبرير يُعمي البصيرة.
لسنا أدوات هدم، ولسنا شهود زور. لسنا معنيين بإحباط أي مسؤول لمجرد الإحباط، لكننا أيضًا لن نكون غطاءً لإخفاق أو فساد. من لا يحتمل النقد، لا يحتمل المسؤولية، ومن يطلب الدعم عليه أن يقبل بالمحاسبة.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب المجال العام هو أن يتحول المجتمع إلى متفرج، أو أن يتحول الكُتّاب إلى مروّجين، أو أن تتحول منظمات المجتمع المدني إلى ديكور في مشهد رسمي. عندها فقط يُختطف الإصلاح من مضمونه، ويصبح مجرد خطاب للاستهلاك.
دورنا أن نبقى يقظين، أن نحافظ على مسافة واحدة من الجميع، وأن نمنح ثقتنا بقدر ما يُمنح الناس نتائج. الإصلاح ليس شعارًا، بل ممارسة يومية، ونحن جزء من معادلة نجاحه أو فشله.
فإن أحسن المسؤولون، كنا أول من يثمن. وإن أخفقوا، كنا أول من ينبه. هكذا تُبنى الحياة العامة، لا بالصمت، ولا بالصخب، بل بكلمة مسؤولة، وموقف واضح، وضمير لا يساوم.